ملخص كتاب نظام التفاهة
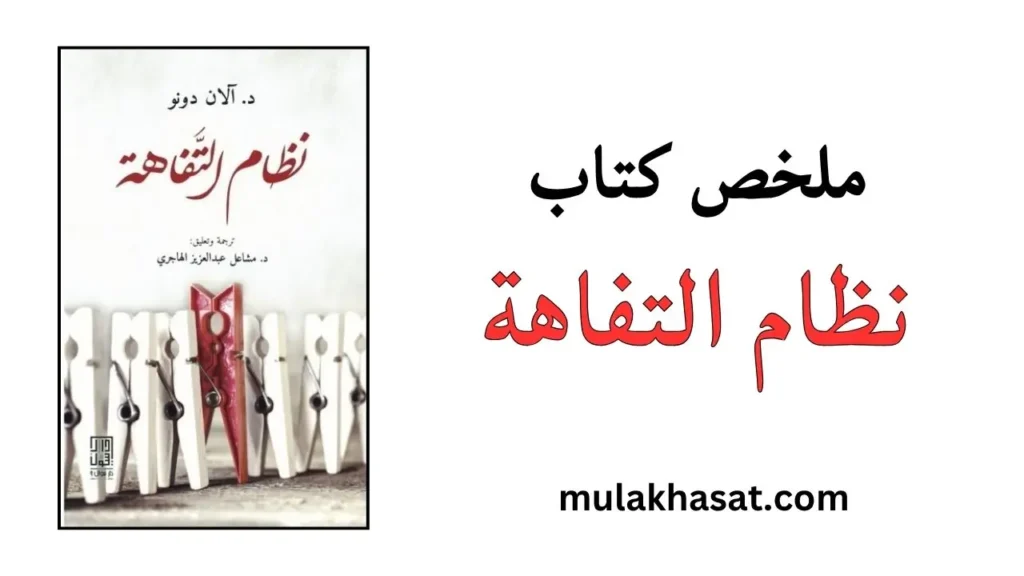
حين تصبح التفاهة قانونًا
في زمنٍ كانت تُرفع فيه القامات العالية من مفكرين وفلاسفة وعلماء، انقلب الحال. لم يعد للمعرفة وزن، ولا للفكر مكان، وكأن العالم قرر أن يستبدل الجوهر بالقشرة، والعمق بالسطح، والمعنى بالشكل. يفتح آلان دونو كتابه “نظام التفاهة“ بهذه الحقيقة الصادمة، ليصف واقعًا مألوفًا لكننا كثيرًا ما نتغافل عنه: “لقد تغيّر مفهوم السلطة، فلم تعد ترتكز على المعرفة ولا حتى على المال، بل على القدرة على التماهي مع النظام القائم دون أن تُحدث فيه خلخلة.”
لقد أصبح الطريق إلى النجاح لا يمر عبر الاجتهاد أو الابتكار، بل عبر الانسجام مع المنظومة، أي أن تكون “قابلًا للتسويق”، كما يقول الكاتب. أن تتحدث بلغة السوق، تلبس ما يتوقعه الناس، تقول ما يريحهم، ولا تزعجهم بأسئلة ثقيلة أو آراء مزعجة. وكأن لسان حال هذا العصر يقول: “خليك في السليم”، مثلما اعتدنا أن نسمع في الشارع العربي حين يُطلب من أحدهم ألا يعترض أو يخرج عن الخط.
يضرب دونو أمثلة من واقعنا المعاصر، ويقارنها بماضٍ لم يكن مثاليًا، لكنه كان يمنح للمعرفة مكانتها. كان المفكر يُحترم، والمبدع يُقدّر، أما اليوم، فالعالم “يُدار على يد تقنيين بلا رؤية، ومديرين بلا قيم، وإعلاميين بلا مهنية”، كما يقول. التفاهة لم تعد انحرافًا عن القاعدة، بل أصبحت هي القاعدة نفسها. وهذا أخطر ما في الأمر.
ينتشر هذا النظام كما ينتشر السراب في الصحراء، يخدع العيون، ويمنح شعورًا زائفًا بالإنجاز. تجد المسؤول يتحدث كثيرًا دون أن يقول شيئًا، والمثقف يُصفق للسلطة بدل أن يُسائلها، والطالب يسعى إلى الشهادة لا إلى العلم. في كل مجال، هناك آلية دقيقة تُقصي من يفكر، وتُكافئ من يُجيد التكرار.
ولعل أخطر ما يشير إليه دونو هو أن هذا النظام لا يفرض نفسه بالقوة، بل بالرضا الجماعي. الجميع يشارك فيه – ولو بصمت – لأنه مريح، لا يتطلب جهدًا فكريًا، ولا مواجهة. وكما يقال المثل الشهير: “من خاف سلم”، لكن دونو يرى أن هذا الخوف هو ما يجعل التفاهة تنتصر.
الكتاب ليس دعوة للبكاء على الأطلال، بل هو محاولة لفهم: كيف ساد التافهون؟ ولماذا رضخ العقلاء؟ وما الثمن الذي ندفعه جميعًا حين نُقصي الفكر، ونُعلي من شأن الرداءة؟
النخبة تختفي… والتافهون يصعدون
في الماضي، كان يُنظر إلى أصحاب العقول النيرة على أنهم مرجعيات المجتمع. المفكر كان يُستشار، والمثقف كان يُهاب، وصاحب الموقف كان يُحترم حتى لو خالف السائد. أما اليوم، فكما يوضح آلان دونو، تمّت إزاحة هؤلاء بهدوء… دون ضجيج، ودون مقاومة.
في ظل نظام التفاهة، لم يعد للعمق مكان. حلّ مكان المفكر الحقيقي من يُجيد لعب الأدوار، ويتقن فن الظهور، ويعرف “من يُرضي” و”كيف يُصمت”. هؤلاء لا يسألون: لماذا؟ ولا يقولون: لا. بل يتقنون فن البقاء داخل اللعبة، لعبة المصالح، والولاءات، والمظاهر.
النخبة لم تختفِ لأنها ماتت، بل لأن النظام لم يعُد يسمح بوجودها. المفكر الصادق يُعتبر خطرًا، لأنه يكشف العيوب، ويزعج التوافق الزائف. لذلك، يتم تهميشه، والتقليل من شأنه، وربما اتهامه بـ”عدم الواقعية” أو “السلبية”. في المقابل، يتم تمكين التافه، لأنه لا يُشكّل تهديدًا، بل هو حلقة سهلة في سلسلة الطاعة والانصياع.
يضرب الكاتب مثالًا بالإدارات الحديثة، حيث يتم اختيار المديرين لا بناءً على رؤاهم أو كفاءاتهم، بل على قدرتهم على تجنّب المشاكل، وتقديم أنفسهم كـ”منفذين مطيعين” لا كـ”قادة مفكرين”. وبنفس المنطق، يتم تصعيد السياسي الذي يُجيد تكرار الخطابات لا الذي يطرح حلولًا جذرية، ويتم تمجيد الإعلامي الذي يُرضي الجميع على حساب من يزعجهم بالحقيقة.
تأمل في واقعنا، وستجد تجليات هذا النظام في كل زاوية: أناس يصعدون بلا رصيد فكري، فقط لأنهم يجيدون المجاملة، وتجنب الخلاف، وتكرار المقولات الرائجة. كما يقال في أحد الأمثال الشعبية: “اللي ما له ضَرْب، ما عليه غُبار” – أي أن من لا يسبب المشاكل، لا يُمس.
والنتيجة؟ منظومة متكاملة من الأشخاص الذين ينجحون في البقاء… لا في الإبداع. ينجحون في تسلق السلم… لا في حمل رسالة. وهذا هو جوهر نظام التفاهة: أن يُقصي أصحاب القيمة، ويُلمّع من لا يحمل شيئًا سوى قدرته على الصمت والتمثيل.
المال يشتري كل شيء
في نظام التفاهة، المال ليس وسيلة للعيش فقط، بل أصبح مقياس النجاح الوحيد. لم تعد القيمة تُقاس بما يقدمه الإنسان من معرفة أو أخلاق أو مواقف، بل بحجم ما يملكه في رصيده البنكي، أو عدد متابعيه، أو حجم أرباحه… حتى وإن كانت على حساب الكرامة أو المبدأ.
يشرح آلان دونو كيف تحوّل منطق السوق إلى مبدأ حاكم في كل شيء. فبدل أن تكون السوق أداة لتنظيم الاقتصاد، أصبحت عقيدة تتسلّل إلى التعليم، والإعلام، والسياسة، بل وحتى الفن. وصار كل ما لا يُدرّ أرباحًا يُعتبر غير مهم، أو غير نافع، أو “ترف فكري”.
في ظل هذا النظام، كثير من المهن فقدت شرفها. الطبيب يُصبح تاجر خدمات، الأستاذ يتحوّل إلى موظف يوزّع علامات، والصحفي يبحث عن “الترند” لا عن الحقيقة. لم يعد السؤال: هل هذا العمل مفيد للمجتمع؟ بل: كم سيُدرّ من المال؟ وكأن كل شيء قابل للبيع… حتى الضمير.
الكاتب يُشير بحدة إلى أن الفكر النقدي، الذي كان يُعتبر دليلًا على النضج والوعي، صار مزعجًا، لأنه لا يُدرّ ربحًا سريعًا. وبدل أن يُكافأ صاحب الموقف، يُهمّش لأنه “لا يفهم السوق”، أو لأنه “يعقد الأمور”. لقد أصبح من الطبيعي أن يُطلب من المثقف أن يُبسّط فكره حتى يكون “قابلًا للتسويق”، تمامًا كما يُطلب من المنتج أن يُقلّص تكاليفه حتى يُباع أكثر.
تأمل في المشهد الإعلامي اليوم، مثلًا، وستجد أن أكثر من يُشاهد هم من يُقدّمون محتوى فارغًا، لكنه مربح. يتم تمجيدهم كنجوم، فقط لأنهم يجذبون الإعلانات. أما الصحفي الذي يكتب بعمق ويتقصّى الحقيقة، فهو منسيّ في الزاوية. لكن في هذا الزمن، إن لم تكن تبيع، فليس لك وجود أصلًا.
لا يُدين دونو السوق بحد ذاته، بل يُدين حين تصبح المعيار الوحيد لكل شيء. حين يُطلب من الإنسان أن يبيع صمته، أو يُساوم على رأيه، أو يتنازل عن مهنته لأجل “الزبون”. وهنا تصبح المسألة أخلاقية، لا اقتصادية فقط.
الإعلام يصنع نجوماً من ورق
في عصر نظام التفاهة، تحوّل الإعلام من أداة لنقل الحقيقة، إلى مصنع كبير لإنتاج “نجوم من ورق”. نجوم لا يملكون فكرًا ولا موقفًا، لكنهم يتقنون فن الظهور، ويتحدثون كثيرًا دون أن يقولوا شيئًا حقيقيًا.
يُوضّح آلان دونو أن وسائل الإعلام، بدل أن ترفع من شأن العقول الجادة، أصبحت تلمّع من يرضون الجميع، ويتحدثون بلغة خفيفة، لا تُثير الجدل ولا تُزعج أصحاب النفوذ. الإعلامي الناجح في هذا النظام ليس من يملك المعلومة أو يطرح الأسئلة الصعبة، بل من يستطيع أن يُضحك، ويُبسط، و”يمشي جنب الحيط”، كما نقول في لهجتنا العامية.
البرامج السياسية تُقدَّم بطريقة استعراضية، النقاشات تُدار وكأنها عروض ترفيهية، والضيوف يتم اختيارهم حسب قدرتهم على جذب الانتباه، لا حسب عمق أفكارهم. لم يعُد المهم أن تقول شيئًا مهمًا، بل أن تقول شيئًا “يشدّ”، حتى لو كان تافهًا أو خاطئًا. المهم أن “تُصنع لحظة تلفزيونية” لا أن تصنع وعيًا.
أما المثقفون الحقيقيون، فهم إما مغيبون، أو يتم تشويه صورتهم على أنهم “معقدون”، أو “سلبيون”، أو “لا يفهمون لغة العصر”. في عالم الإعلام الجديد، يجب أن تتحدث كأنك نجم على السوشيال ميديا، لا كأنك مفكر يحاول أن يُنير العقول. وهكذا، يتم تدريجيًا تهميش كل من يملك شيئًا يُقال، لصالح من يُجيد اللعب بالكلمات دون مضمون.
ويضرب الكاتب مثالًا بالإعلامي الذي يصبح “مؤثرًا” فقط لأنه يتقن الحركات والابتسامات، لا لأنه يحمل رسالة. وهكذا، يتحول الإعلام من سلطة رقابية تُحاسب، إلى مسرح كبير يُسلّي، ويُخدّر، ويُلهي الناس عن الأسئلة الحقيقية.
في هذا السياق، يمكن فهم كيف أن منصات الإعلام ترفع من شأن تافهين فقط لأنهم “خفاف الظل” أو “مشاهير”، وتُقصي من يجرؤ على التفكير بصوت مرتفع. لأن في هذا النظام، فحتى “الكبير” يُفصَّل على مقاس الجمهور… لا على مقاس الحقيقة.
التعليم ينتج موظفين لا مفكرين
في ظل نظام التفاهة، تحوّلت المؤسسات التعليمية إلى مصانع لإنتاج “أدوات بشرية” جاهزة لسوق العمل، لا لعالم الفكر. لم تعُد المدارس والجامعات تصقل العقل أو تُنمّي التساؤل، بل تُدرّب الطالب على طاعة الأوامر، وحفظ القواعد، وتنفيذ المطلوب دون نقاش.
يقول آلان دونو إن الهدف من التعليم لم يعُد تكوين إنسان حر يفكر، بل “إعداد موظف” يعرف كيف يجيب في الامتحان، ويُرضي الأستاذ، ويجمع الشهادات واحدة تلو الأخرى. وهكذا، أصبحت الشهادة أغلى من الفكرة، والرتبة الأكاديمية أثمن من المهارة الحقيقية.
الطالب المتفوّق ليس من يفكّر خارج الصندوق، بل من يحفظ النموذج ويكرره بإتقان. ومن يطرح الأسئلة الجريئة قد يُعتبر “مشاغبًا” أو “سلبيًا”، لأنه يُربك النظام، ولا “يمشي حسب المنهج”. فكل ما هو خارج الكتاب مرفوض… حتى لو كان أقرب للحياة.
النتيجة؟ أجيال كاملة من الخريجين الذين يُجيدون تقديم أنفسهم، لكن لا يملكون رأيًا حقيقيًا. يعرفون كيف يكتبون سيرة ذاتية ممتازة، لكن لا يعرفون لماذا يفعلون ما يفعلونه. يملكون شهادات عليا، لكن عقولهم مُقيّدة بـ”نموذج الجواب الصحيح”.
ويُضيف دونو أن النظام التعليمي فقد رسالته الأساسية حين أصبح يُقاس بالأرقام فقط: كم عدد الخريجين؟ كم نسبة النجاح؟ كم علامة حصل عليها الطالب؟ أما الأسئلة الجوهرية مثل: ماذا تعلّم فعليًا؟، وهل أصبح أقدر على التفكير؟، فقد أصبحت “ترفًا لا ضرورة له”.
في عالمنا العربي، يمكننا أن نلمس هذه الظاهرة بوضوح: الطالب يُكرم لحفظه لا لفهمه، والمُعلم يُقيّم بعدد الناجحين لا بجودة ما زرعه في العقول. وكما يقول المثل: “احفظ تُنجح، انسَ تُفشل”، وهذه هي خلاصة التعليم حين يصبح “مُجرّد تدريب على الوظيفة”.
فبدل أن يكون التعليم أداة تحرّر، أصبح أداة ترويض. لا يُشجّع على النقد، بل على التكيّف. لا يفتح الأفق، بل يُحدد المسار. وهكذا، نُنتج موظفين أكفاء… لكننا نخسر المفكرين.
التافهون يحكمون
في عالم نظام التفاهة، لا يتم اختيار القادة بناءً على ذكائهم أو كفاءتهم أو قدرتهم على الإبداع، بل على قدرتهم على “الاندماج” مع المنظومة، وطاعتهم العمياء للتسلسل الإداري، وتجنّبهم لأي تفكير مستقل قد يُربك “الماكينة”.
يُبيّن آلان دونو أن المناصب العليا – سواء في الإدارة أو السياسة أو حتى في بعض المؤسسات العلمية – أصبحت تُمنَح لمن يجيدون اتباع القواعد، لا لمن يملكون رؤية. فكل من يفكر خارج الخط المرسوم، يُعتبر مصدر تهديد، ويتم استبعاده بـعبارة مهذبة: “لا يتماشى مع روح الفريق”.
يُشبه الكاتب هذا الواقع بمسرحية عبثية، حيث يجلس في المقاعد الأمامية من “يحترفون التملّق”، بينما يُقصى المفكرون الحقيقيون لأنهم “لا يجيدون اللعب”. فيتم مكافأة من يقول “نعم”، ويُعاقب من يقول “ربما”، أو – لا قدّر الله – “لا”.
في هذا السياق، المدير الناجح هو من يحافظ على الوضع كما هو، لا من يُحدث تغييرًا. والسياسي “المحبوب” هو من يُجيد الخطاب العام، لا من يمتلك مشروعًا حقيقيًا. أما الموظف المثالي، فهو الذي “لا يُصدّر مشاكل”، ولو كان ذلك يعني غضّ الطرف عن أخطاء واضحة أو قرارات كارثية.
والأسوأ من ذلك، كما يُشير دونو، أن هذا المناخ يجعل الأشخاص الجادين إما صامتين، أو خارج المنظومة تمامًا. فكلما زاد وعيك وحرصك على المبدأ، قلّت فرصتك في التقدّم. وكأنك في سباق، كلما حملت معك قيمًا ثقيلة… تعثّرت.
ويُذكّرنا هذا المشهد بقول مأثور: “في زمن الرويبضة، يُخوَّن الأمين ويُؤتمن الخائن”. وهذا بالضبط ما يحدث حين يصبح الولاء للمؤسسة أهم من الولاء للحقيقة، والانضباط الظاهري أغلى من الفكرة الجديدة.
التافهون لا يصلون إلى القمة صدفة… بل لأن النظام نفسه تم تصميمه ليُقصي المتميزين، ويُكافئ من “لا يزعج”. وهكذا، لا يعود من الغريب أن ترى في مواقع القرار من لا يعرف شيئًا عن الإدارة، لكنه يعرف كل شيء عن المجاملة.
هل من أمل؟ استعادة المعنى في زمن الرداءة
رغم قتامة المشهد الذي يرسمه آلان دونو، إلا أن كتاب نظام التفاهة لا ينتهي باليأس، بل بدعوة عميقة للوعي والمقاومة الهادئة. فوسط هذا الطوفان من السطحية، يذكّرنا الكاتب بأن المعنى لم يمت، بل تم إقصاؤه… وأن استعادته ممكنة، لكنها تبدأ من الداخل، من الفرد نفسه.
المؤلف لا يطلب ثورة صاخبة، بل يقترح ما يُسمّيه “المقاومة الصامتة”: أن ترفض التفاهة من موقعك، ولو بصمت. أن تُعيد الاعتبار للأفكار العميقة، للنقاش الجاد، للمعرفة الحقيقية، وللكرامة في زمن يتم فيه تسليع كل شيء.
يدعونا دونو إلى إعادة الاعتراف بقيمة الإنسان كمفكر، كصاحب موقف، ككائن له رسالة، لا مجرد أداة إنتاج أو مستهلك في ماكينة عملاقة. يبدأ الأمل حين يرفض الأستاذ أن يكون “موظفًا إداريًا”، وحين يرفض الطبيب أن يتحوّل إلى “تاجر خدمات”، وحين يرفض الإعلامي أن يكون “مؤثّرًا خالي الفكر”.
ويُصرّ المؤلف على أن الخطر الأكبر ليس في وجود التفاهة، بل في قبولها كأمر طبيعي. حين تصبح اللامعنى عادة، يصبح من يتساءل هو الشاذّ، ومن يصمت هو البطل. لذلك، يُعيدنا إلى جذور الفلسفة: التفكير، النقد، الوعي… لا كترفٍ فكري، بل كفعل مقاومة.
في عالم يزداد ضجيجُه، تصبح الكلمة الهادئة فعلًا ثوريًا. وفي زمن تُكافأ فيه الرداءة، يصبح الحفاظ على المعنى بطولة.
خلاصة القول: نعم، هناك أمل. لكنه يتطلّب شجاعة… شجاعة أن تكون مختلفًا، أن تفكّر حين يُطلب منك أن تطيع، أن تطرح الأسئلة حين يطلبون منك أن تبتسم فقط. الأمل يبدأ حين نرفض أن نكون جزءًا من القطيع.
ختاما – لا تكن جزءًا من القطيع
في زمنٍ أصبحت فيه التفاهة هي القاعدة، والسطحية هي الأسلوب السائد، والغوغاء هم المقياس، فإن أبسط أشكال الوعي تتحوّل إلى عمل نادر… وشجاع. نظام التفاهة ليس كتاب يُنتقد فيه الواقع، بل مرآة تضع أمامنا صورة ما وصلنا إليه، وتدعونا لا لكسرها، بل لفهمها، والانطلاق منها نحو تغيير هادئ… وعميق.
أن تفكّر في زمن الرداءة هو تحدٍّ. أن تطرح سؤالًا حقيقيًا حين يكتفي الجميع بالشعارات، هو تمسّك بجوهر الإنسان. أن ترفض أن تكون نسخةً مكرّرة ممن سبقك، هو بداية طريق المعنى.
لذا… لا تنجرّ مع التيار. لا تُصفّق لأن الجميع يصفّق. لا تُساير لأن الصمت أسهل. بل كن ذلك الصوت المختلف، حتى لو لم يسمعك أحد. فالمعنى لا يحتاج جمهورًا، بل يحتاج صدقًا. وصدقك – ولو كان صامتًا – قد يكون شرارة توقظ وعيًا نائمًا.
وفي النهاية، كما قال دونو:
“حين يُصبح التفاهة نظامًا… فالمعنى يصبح مقاومة.”
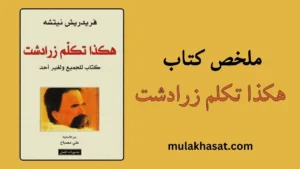
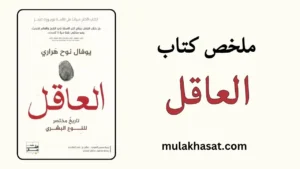
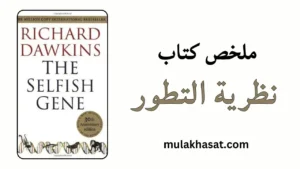
التعليقات مغلقة.