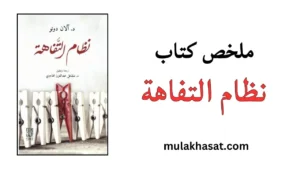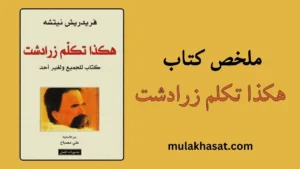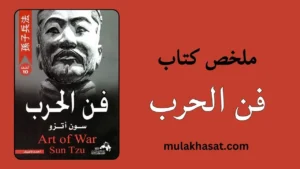ملخص كتاب سيكولوجية الجماهير – غوستاف لوبون
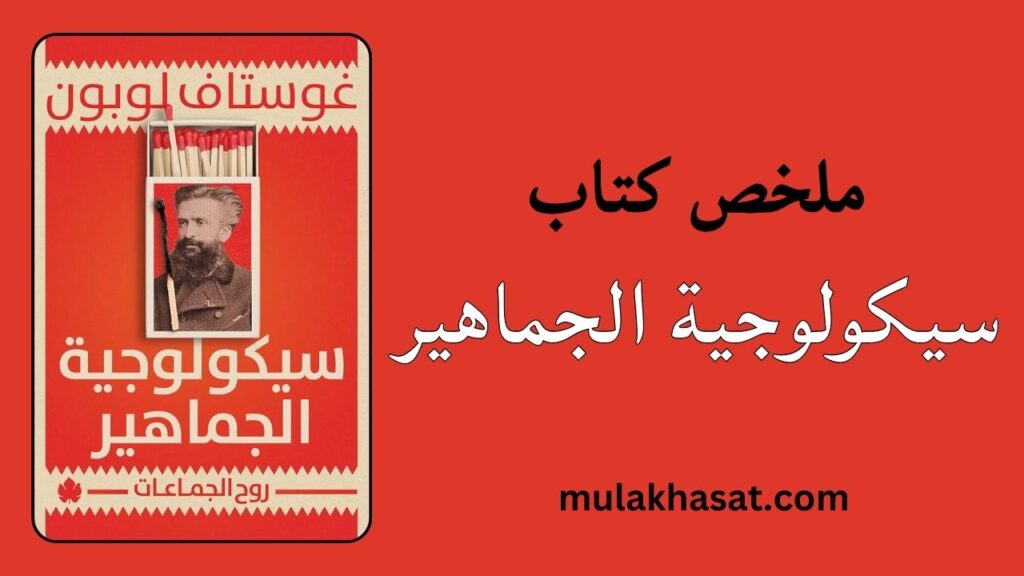
هل تساءلت يومًا لماذا تتحرك الجماهير بشكل غير عقلاني في لحظات حاسمة؟ في كتابه “سيكولوجية الجماهير“، يوضح لوبون الفرق الجوهرى بين سلوك الفرد والجماعة. بينما يتصرف الأفراد وفقًا لفهمهم الشخصي للأشياء، نجد أن الجماهير تتحرك بدافع عاطفي بعيد عن المنطق والعقلانية.
في رأي لوبون، يفقد الأفراد داخل الجماعات قدرتهم على التفكير النقدي، ويصبحون مجرد أدوات لتنفيذ مشاعر جماعية غير منطقية. واصفًا الجماهير بأنها تتصرف ككائن واحد، حيث يتسم العقل الجمعي في لحظات معينة بالاندفاع والعاطفية، مما يجعلها سهلة التأثر بالأفكار والمشاعر المشتركة.
إذا نظرنا إلى الثورات العربية، نرى كيف تحركت الجماهير بناءً على مشاعر قوية وشعارات حماسية دون التفكير في العواقب. هذا السلوك، كما يراه لوبون، هو محرك رئيسي لبعض الأحداث التاريخية الكبرى.
تمامًا كما في الحروب، تُحفَّز الجماهير من خلال الرموز والشعارات، مما يجعل قوتها غير قابلة للسيطرة عندما تتوحد مشاعرها. يرى لوبون أن الجماهير غالبًا ما تتخذ قرارات متهورة ومدفوعة بالعاطفة، بدلًا من العقلانية والتخطيط المدروس.
وهذا ما سنلخصه في هذا الكتاب من خلال تسليط الضوء على تأثير العقل الجمعي وكيفية تأثيره في تحولات الأحداث الكبرى في التاريخ. لنبدأ!
الخصائص النفسية للجماهير
يواصل لوبون تحليل خصائص الجماهير النفسية، مؤكدًا أن الجماهير، بسبب تفاعلها العاطفي، تتسم بعدد من السمات التي تجعلها تختلف تمامًا عن الأفراد. الجماهير لا تنظم أفكارها بشكل عقلاني، بل تسير في الغالب وفقًا للاندفاعات العاطفية التي تسيطر عليها. يشير لوبون إلى أن هذه الظاهرة تنشأ من غياب الشعور بالمسؤولية الفردية، وهو ما يجسد مفهوم “اللامسؤولية الجماعية”.
تتمثل أبرز خصائص الجماهير في الغياب التام للمنطق، إذ يتناغم الأفراد مع مشاعر جماعية قد تكون بعيدًا عن الواقع. هذه المشاعر، التي يتم تحفيزها غالبًا بالكلمات البسيطة والمباشرة، تجعل الجماهير أكثر استجابة لأي دعوة حماسية مهما كانت سطحية. في هذا السياق، يقول لوبون:
“عندما تكون الجماهير غاضبة، تصبح بغيضة؛ وعندما تكون سعيدة، تصبح طائشة.”
اللامسؤولية الجماعية هي سمة أخرى يبرزها لوبون، حيث يرى أن الأفراد داخل الجماهير لا يتحملون المسؤولية الفردية عن أفعالهم. هذا قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات جماعية خاطئة أو حتى تصرفات عنيفة، كما يحدث في حالات الشغب أو الاحتجاجات العفوية. فالتحرك الجماعي غالبًا ما يتسم بالخفة وعدم الاتزان.
أما في الثقافة العربية، نجد أن الشعوب قد تتأثر بشكل واضح بهذه الظواهر، كما رأينا في حركات احتجاجية أو انتفاضات جماعية كانت ناتجة عن تأثير قوي لخطاب حماسي أو شعارات مثيرة للعواطف. على سبيل المثال، في ثورات الربيع العربي، كان التحرك الجماعي مدفوعًا بمشاعر الغضب من الأنظمة الحاكمة، ما جعل الأفراد في الجماهير يتخذون مواقف قد لا يكونون ليتخذوها لو كانوا بعيدين عن تأثير الحشد.
كذلك، في العصور القديمة، كان القادة العظماء يعرفون جيدًا كيفية تحفيز هذه المشاعر الجماعية، على سبيل المثال، القائد العربي صلاح الدين الأيوبي، الذي كان لديه القدرة الفائقة على تحفيز قواته عبر خطاباته الحماسية التي تستثير مشاعرهم، رغم أنهم لم يكونوا دائمًا على دراية تامة بكل تفاصيل المعركة. هذا النوع من التأثير الذي يمارسه القادة على الجماهير يبرز قوة التوجيه العاطفي على العقل.
وفي هذا السياق، لا يتوقف لوبون عند غياب المنطق فقط، بل يشير إلى أن الجماهير تحاكي سلوك الأفراد الآخرين في المجموعة. أي أنه عندما يتصرف أحد أفراد الجماعة بطريقة معينة، يميل الآخرون إلى تقليده، مما يخلق نوعًا من “العدوى العاطفية” التي تساهم في تعزيز المشاعر الجماعية. يُظهر هذا بوضوح كيف أن الجماهير تميل إلى التحرك بشكل جماعي دون تحليل أو تمييز.
في النهاية، يمكننا القول إن فهم سلوك الجماهير يتطلب إدراك هذه الخصائص النفسية التي تميزها عن الأفراد. إن الجماهير لا تتسم بالتفكير النقدي بل تستجيب بشكل سريع للمؤثرات العاطفية التي تخلقها القيادة أو الظروف المحيطة بها.
كيف تؤثر القيادة على الجماهير
في هذا القسم، يركز لوبون على دور القائد في توجيه الجماهير، مشيرًا إلى أن القيادة هي العامل الحاسم في تشكيل سلوك الجماعات. يعتبر لوبون أن القائد الذي يستطيع تحفيز العواطف وتوجيه المشاعر الجماعية هو الشخص القادر على تشكيل المسار الذي ستسير عليه الجماهير. الجماهير بطبيعتها لا تمتلك القدرة على التفكير العقلاني المعقد، ولذلك فهي تتبع القادة الذين يمتلكون القدرة على إثارة مشاعرهم، سواء كانت تلك المشاعر مشاعر خوف، أمل، أو حماسة.
فالقائد المؤثر، كما يراه، لا يحتاج إلى تقديم حجج منطقية معقدة أو عرض أفكار مبنية على أسس عقلية. ما يحتاجه القائد هو تقديم رسائل مختصرة وقوية تؤثر في مشاعر الجماهير بشكل مباشر. يذكر لوبون مثالًا واضحًا عن الخطابات الحماسية التي ألقاها بعض القادة العسكريين والسياسيين عبر التاريخ، مثل نابليون بونابرت، الذي كان يتمتع بقدرة فائقة على إثارة مشاعر الجنود والمواطنين، مما جعلهم على استعداد للقتال في ظل ظروف قاسية للغاية.
في إحدى المقاطع، يقول لوبون: “الجماهير لا تتبع الحقائق بل تتبع الرموز، لذلك فإن القائد الذي يستطيع خلق رمز قوي في أذهان الجماهير هو الذي يتحكم في مسارهم.” هذه الفكرة تشير إلى أن القوة الحقيقية للقائد لا تكمن في منطق أفكاره، بل في قدرته على تكوين صورة قوية أو رمز ملهم في عقول الناس. وبذلك، تصبح الرؤية العاطفية للقائد أكثر تأثيرًا من الرؤية العقلانية.
في العديد من الأمثلة، قد يكون أثر القيادة على الجماهير في التاريخ واضحًا، فمثلًا في التاريخ العربي، نجد أن القائد صلاح الدين الأيوبي استطاع أن يلهم جيشه خلال معركة حطين، ليس فقط بالكلمات، بل بموقفه القوي والمبدئي الذي شكل رمزًا للقيم النبيلة مثل الشجاعة والعدالة. هذا التأثير لم يكن محصورًا في أفراد الجيش فقط، بل كان له تأثير كبير على الجماهير في البلدان التي حررها صلاح الدين من الصليبيين.
لكن، القيادة لا تتوقف فقط على تأثير الكلمات، بل تمتد أيضًا إلى القدرة على التأثير بالمشاعر. فالقائد الذي يمتلك القدرة على جعل الجماهير يشعرون بأنهم جزء من شيء أكبر، غالبًا ما يحقق تأثيرًا طويل الأمد. مثال آخر في تاريخنا الحديث يمكن أن يكون التأثير الكبير الذي مارسته شخصيات مثل جمال عبد الناصر في مصر؛ فقد تمكن من توجيه الجماهير بفضل كاريزميته وقدرته الفائقة على تحفيز مشاعر القومية العربية. كل خطاب كان يحمل رمز قوي، مما جعل الجماهير لا تقتصر على تأييده بل أيضًا على تقديم تضحيات هائلة في سبيل ما كان يرمز إليه.
لكن لا تقتصر هذه القوة على القادة السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا قادة الفكر والفلسفة. مثلا، في العصر الحديث، نجد تأثيرات القادة مثل مارتن لوثر كينغ في حركات حقوق الإنسان، حيث كانت كلماته البسيطة قوية تجمع الجماهير حول قضية واحدة وهي المساواة.
في النهاية، يبقى القائد الفعال هو الذي يعرف كيف يلامس مشاعر الجماهير، ويغذيها بالطاقة العاطفية التي تدفعها إلى العمل دون التفكير في العواقب أو التأثيرات المنطقية. وهذا ما يميز القادة المؤثرين عن غيرهم، فالقائد الذي يملك القدرة على خلق رؤية عاطفية قوية يكتسب القدرة على التحكم في المسار الجماعي.
العوامل التي تؤثر في تكوين الجماهير
في هذا القسم، يسلط لوبون الضوء على العوامل التي تساهم في تشكيل الجماهير وتحديد سلوكها. فالجماهير لا تظهر بشكل عشوائي، بل تنشأ نتيجة تفاعل مجموعة من الظروف الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية التي تتجمع وتدفع الأفراد للانضمام إلى الحشود والتفاعل معها. هذه العوامل يمكن أن تكون مؤقتة أو طويلة الأمد، لكنها تؤثر بشكل كبير على شكل الجماعات وكيفية تصرفها.
أحد أبرز العوامل التي يذكرها لوبون هو الظروف الاجتماعية. فالجماهير غالبًا ما تنشأ في فترات الأزمات الاجتماعية أو التغيرات الجذرية في المجتمع. على سبيل المثال، في فترات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، يصبح الناس أكثر عرضة للتجمع والتفاعل مع بعضهم البعض، مما يسهل تشكيل الجماهير. هذا ما نشهده في الثورات أو الحركات الاحتجاجية التي تظهر عادة نتيجة لحالة من الإحباط الجماعي.
وفي هذا السياق، يعود لوبون إلى دراسة ثورات مثل الثورة الفرنسية، حيث كان الاضطراب الاجتماعي والحاجة إلى التغيير عاملين مهمين في تشكيل الجماهير التي خرجت إلى الشوارع تطالب بالحرية والمساواة. ليس هذا فحسب، بل كانت الأوضاع الاقتصادية الصعبة – مثل الفقر وارتفاع الأسعار – تلعب دورًا في زيادة الغضب الجماعي وتحفيز الأفراد على المشاركة في الأحداث الثورية.
علاوة على ذلك، يتحدث لوبون عن العوامل النفسية أيضا التي تدفع الأفراد إلى الانضمام إلى الجماهير. عندما يكون الأفراد في حالات من التوتر النفسي أو العاطفي، يصبحون أكثر عرضة للانضمام إلى الجماعات التي تقدم لهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم أو حتى للهرب من الواقع.
تمثل الأنظمة السياسية أيضًا عاملًا آخر له تأثير عميق في تشكيل الجماهير. حيث يرى لوبون أن الأنظمة الاستبدادية غالبًا ما تستخدم الدعاية والإعلام كأدوات لتوجيه الجماهير نحو أهداف معينة. القائد الذي يعرف كيف يوجه الإعلام أو يخلق صورة معينة في ذهن الجماهير يستطيع أن يشكل أفكارهم وقراراتهم بشكل فعال. في هذا الصدد، نجد أن الكثير من الأنظمة السياسية الحديثة والقديمة كانت قادرة على تحفيز الجماهير من خلال إشاعة أفكار بسيطة ولكن مؤثرة، غالبًا ما تكون مرتبطة بالقومية أو الخوف من عدو خارجي.
مثال حي على ذلك هو ما كان يحدث في بعض الأنظمة العربية في العقود الماضية، حيث كان الإعلام الرسمي يُستخدم بشكل مكثف لبث رسائل معينة تهدف إلى تشكيل وعي جماهيري محدد. فالجماهير لم تكن تستمع إلى الحقائق أو تبحث عن المعلومات، بل كانت تنجذب إلى الرسائل التي كانت تتوافق مع عواطفهم ورغباتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تتأثر الجماهير بالظروف الاقتصادية. فالأزمات الاقتصادية والارتفاع المستمر في معدلات البطالة يمكن أن تكون عوامل محفزة لظهور الجماهير المتحركة، حيث يسهل في مثل هذه الحالات تحفيز الناس على الانضمام إلى الاحتجاجات أو الحركات الاجتماعية. هذه الجماهير، التي تتشكل في غياب الفرص الاقتصادية، تصبح أكثر قابلية للتأثر بالقادة الذين يعدونهم بتغيير الأوضاع.
في الختام، يمكن القول إن الجماهير لا تتشكل في فراغ، بل هي نتاج تفاعل معقد بين العوامل الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، والسياسية. إذا كانت الظروف مناسبة، فإن الجماهير ستظهر، والأفراد سينجذبون إلى هذه الجماعات بشكل عاطفي، مما قد يؤدي إلى سلوك جماعي غير عقلاني، بحسب ما وصفه لوبون.
الجماهير في التاريخ
يستعرض لوبون في هذا القسم تأثير تطور الجماهير عبر التاريخ، موضحًا كيف لعبت الجماهير دورًا محوريًا في أحداث تاريخية فارقة. يرى لوبون أن الجماهير ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل كانت دائمًا عنصرًا قويًا في مسار التاريخ البشري. فعندما تلتقي المشاعر الجماعية مع الظروف السياسية والاجتماعية المناسبة، يمكن للجماهير أن تُغير مجرى التاريخ بشكل غير متوقع.
واحدة من أبرز الحالات التي يسلط عليها لوبون الضوء هي الثورات الكبرى التي شهدها التاريخ. يذكر بشكل خاص الثورة الفرنسية، التي كانت نتيجة لتجمع مشاعر الإحباط والغضب في المجتمع الفرنسي تجاه النظام الملكي. الجماهير في تلك الفترة، التي كانت تتكون أساسًا من الفقراء والعوام، تم تحفيزها بالعواطف مثل الظلم والحرمان، وأدى ذلك إلى اندلاع ثورة غيرت شكل المجتمع الفرنسي والعالم بأسره. في هذه الثورة، لم يكن العقل الجماعي يسعى لتحقيق أهداف منطقية، بل كان مدفوعًا بمشاعر حماسية وعاطفية، الأمر الذي جعل الجماهير قادرة على التخلص من النظام القديم دون التفكير في العواقب.
في هذا الصدد، يذكر لوبون أن القوة التي تولدها الجماهير في مثل هذه الثورات تأتي من “الاندفاع الجماعي”، حيث تصبح الجماعات أقوى من الأفراد، ويتحول سلوكهم إلى قوة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة. يقول لوبون:
“عندما تأخذ الجماهير مسارها، فإنها لا تعرف حدودًا، وكلما زاد عدد الأفراد في الجماعة، زادت قوة العاطفة، وأصبح التأثير أكبر.”
عند الحديث عن الحروب الكبرى، يوضح لوبون كيف أن الجماهير كانت دائمًا جزءًا من الآلية التي تقود الحروب أو تحول مجرى تاريخها. في الحروب العالمية الكبرى، مثل الحرب العالمية الأولى والثانية، كانت الجماهير في كل جانب من الصراع تندفع نحو دعم حكوماتها دون تردد، مدفوعة بمشاعر وطنية عميقة. وقد لعبت خطابات القادة العسكريين مثل ونستون تشرشل، الذي كان له تأثير هائل على الشعب البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، دورًا رئيسيًا في تحفيز الجماهير ورفع معنوياتهم في مواجهة التهديدات.
في التاريخ العربي، نجد أن الشعوب كانت تميل إلى أن تكون في قلب التحولات الكبرى، كما حدث في ثورات الربيع العربي. كانت هذه الثورات، التي بدأت في تونس وامتدت إلى عدة دول عربية، عبارة عن مظاهرات جماهيرية ضخمة ترفع شعارات تتعلق بالحرية والعدالة الاجتماعية. الجماهير في هذه الثورات كانت تتصرف بشكل جماعي وبانفعال عاطفي، حيث تم تحفيزهم ليس فقط ضد الأنظمة الحاكمة، بل أيضًا ضد الظلم والفقر الذي عانوا منه لسنوات.
تاريخياً، يظهر أيضًا كيف أن الجماهير يمكن أن تتبنى قضايا غير عقلانية، ولكنها تكون مدفوعة بنوع من الأمل أو الحلم المشترك. فمثلاً، كانت الجماهير خلال فترات الديكتاتوريات في بعض البلدان تتبع قادة مستبدين على الرغم من أن هؤلاء القادة قد لا يكونون قد قدموا حلولاً منطقية لمشاكل البلاد. لكن وجود الرؤية العاطفية كان يخلق نوعًا من الوحدة بين الناس، بحيث يصبحون قادرين على مواجهة التحديات معًا، لكن بدون التفكير في العواقب الواقعية لتلك القرارات.
في الواقع، كثيرًا ما تكون الجماهير مدفوعة بمشاعر العدالة والحرية أو الخوف والظلم، وهو ما يجعلها قوة هائلة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة. هذا ما أشار إليه لوبون حينما قال: “الجماهير قد تبدو وكأنها كائن حي واحد، ولكنها في الحقيقة تتكون من مشاعر وعواطف متشابكة تنتظر لحظة انفجار.”
دور الإعلام في تشكيل الرأي العام
في هذا القسم، يتناول لوبون دور الإعلام في تشكيل الرأي العام وكيف أنه أصبح الأداة الأقوى التي تستخدمها الحكومات، القادة، وحتى الشركات الكبرى للتأثير على الجماهير. يبرز لوبون أهمية الإعلام باعتباره أداة للسيطرة الجماعية، مؤكدًا أن الإعلام لا يعمل فقط على نقل المعلومات، بل يمكنه أن يوجه الأفكار والمشاعر ويؤثر بشكل عميق في سلوك الجماهير.
يبدأ لوبون بتوضيح فكرة أساسية وهي أن الإعلام ليس محايدًا، بل هو جزء من آلة كبيرة تهدف إلى تشكيل الرأي العام. على الرغم من أن الإعلام في شكله التقليدي يُنظر إليه كوسيلة لنقل الحقائق والمعلومات، إلا أن لوبون يرى أن ما يفعله الإعلام في الواقع هو تحفيز مشاعر الناس وتوجيهها نحو أهداف معينة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
يشير لوبون إلى أن القادة والسياسيين كانوا يدركون منذ القدم أن الكلمة تمتلك قوة كبيرة في تشكيل الأفكار الجماعية. لكن مع تطور الإعلام، أصبح لهذه الكلمة تأثير أقوى. في الماضي، كانت الأخبار تُنقل عبر الصحف والكُتب، ولكن مع ظهور الإذاعة والتلفزيون ثم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح بإمكان أي شخص أن يصل إلى جمهور ضخم في وقت قياسي، مما جعل الإعلام أكثر قوة من أي وقت مضى.
يذكر لوبون في كتابه أنه “عندما تدخل الكلمات إلى أذهان الجماهير، تصبح أقوى من الحقائق نفسها.” هذا يشير إلى أن الناس في الكثير من الأحيان لا يتعاملون مع الحقائق كما هي، بل مع التصورات التي يقدمها الإعلام، وهو ما يجعل الجماهير أكثر عرضة للتأثيرات العاطفية. فعلى سبيل المثال، في الأزمات السياسية أو الحروب، غالبًا ما يتم تلوين الأخبار بمرشحات سياسية أو عاطفية، مما يخلق تصورات مشوهة عن الواقع.
أيضا نجد أن وسائل الإعلام لعبت دورًا كبيرًا في حشد الجماهير خلال الحروب والثورات. على سبيل المثال، في الحرب العالمية الثانية، لعب الإعلام النازي دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام في ألمانيا، حيث استخدم جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في النظام النازي، وسائل الإعلام لنشر أفكار وأيديولوجيات النظام، حتى أصبح الشعب الألماني جزءًا من آلة الدعاية التي غذت الكراهية ضد العدو وشجعت على الوطنية المتطرفة. يشير لوبون إلى أن الإعلام في تلك الفترة كان بمثابة سلاح قوي يمكن أن يوجه المشاعر ويساهم في تشكيل عقول الجماهير.
وفي العالم العربي، يمكننا ملاحظة كيف كان الإعلام جزءًا لا يتجزأ من حركة التغيير في مختلف الفترات التاريخية. على سبيل المثال، في فترة الربيع العربي، لعب الإعلام دورًا أساسيًا في التحفيز على الاحتجاجات. كانت وسائل التواصل الاجتماعي في مقدمة هذه التحركات، حيث استخدمها الشباب لنقل الصور والفيديوهات، وتحفيز الحشود على التظاهر ضد الأنظمة. الإعلام في هذا السياق لم يكن مجرد أداة لنقل الأخبار، بل أصبح أداة لتحفيز الجماهير على اتخاذ مواقف معينة ضد الحكومات والأنظمة الحاكمة.
يقول لوبون:
“إن الإعلام قادر على تحويل أي فكرة إلى عقيدة، وبالتالي يصبح له تأثير بالغ في تشكيل الرأي العام.”
إحدى الظواهر الحديثة التي يعرضها لوبون هي وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت اليوم المصدر الرئيسي للمعلومات (والتضليل) للكثير من الناس. إذا نظرنا إلى التأثير الذي تتركه منصات مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك على سلوك الجماهير، نجد أنها لا تقتصر على نقل الأخبار فقط، بل تساهم في تشكيل الوعي الجماعي وجعل الناس يتبنون وجهات نظر أو آراء قد لا تكون منطقية أو صحيحة.
في الختام، يوضح لوبون أن الإعلام أصبح الأداة الأقوى في يد أي جهة تسعى للسيطرة على الجماهير. إنه أكثر من مجرد وسيلة للأخبار؛ إنه أداة لتشكيل العقول وتوجيه الجماهير نحو أهداف معينة. وهو ما يساهم في تعزيز اللامسؤولية الجماعية، حيث تتبنى الجماهير مشاعر وأفكارًا مستمدة من الإعلام دون التفكير في صحتها أو منطقيتها.
ختاما – تأثير الجماهير في المستقبل
يلخص لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير تأثير الجماهير في التاريخ، ويتطلع إلى تأثيراتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجماهير ستظل دائمًا عنصرًا حاسمًا في تشكيل الأحداث. ومع تقدم الزمن وتطور الأدوات التي تؤثر في الناس، يرى لوبون أن تأثير الجماهير سيزداد قوة وتعقيدًا، خصوصًا مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الإعلام الحديثة.
إحدى النقاط المهمة التي يركز عليها لوبون هي دور التكنولوجيا الحديثة، خاصة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في تعزيز تأثير الجماهير. ورغم أن الجماهير كانت دائمًا موجودة في التاريخ، فإن وسائل الإعلام الرقمية سهلت تحفيزها وتنظيمها في وقت قياسي.
يشير لوبون أيضًا إلى أن الجماهير في المستقبل قد تصبح أكثر تنظيمًا واحترافية بفضل التكنولوجيا. ففي حين كانت الجماهير في الماضي تتجمع بشكل عفوي وعشوائي، فإن التكنولوجيا قد تتيح لها التنظيم المسبق والتخطيط المدروس، مما يزيد من قوتها في التأثير على الأحداث السياسية والاجتماعية.
يقول لوبون في هذا الصدد:
“التكنولوجيا قد تعزز من تأثير الجماهير، ولكنها أيضًا قد تسهم في تزايد الانفعالات العاطفية والآراء المتطرفة.”
وفي النهاية، يعرب لوبون عن قلقه من أن القوة المتزايدة للجماهير قد تؤدي إلى ظهور حركات جماعية متطرفة أو أيديولوجيات متعصبة تهدد استقرار المجتمعات. فالجماهير، كما أظهر في كتابه، يمكن أن تكون عاطفية وغير عقلانية، مما يعرض المستقبل لمخاطر كبيرة إذا لم يتم التعامل مع هذه القوة بعناية.