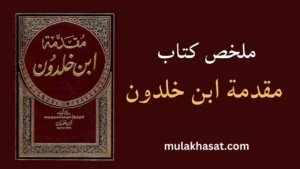ملخص كتاب أمسك بي إن استطعت
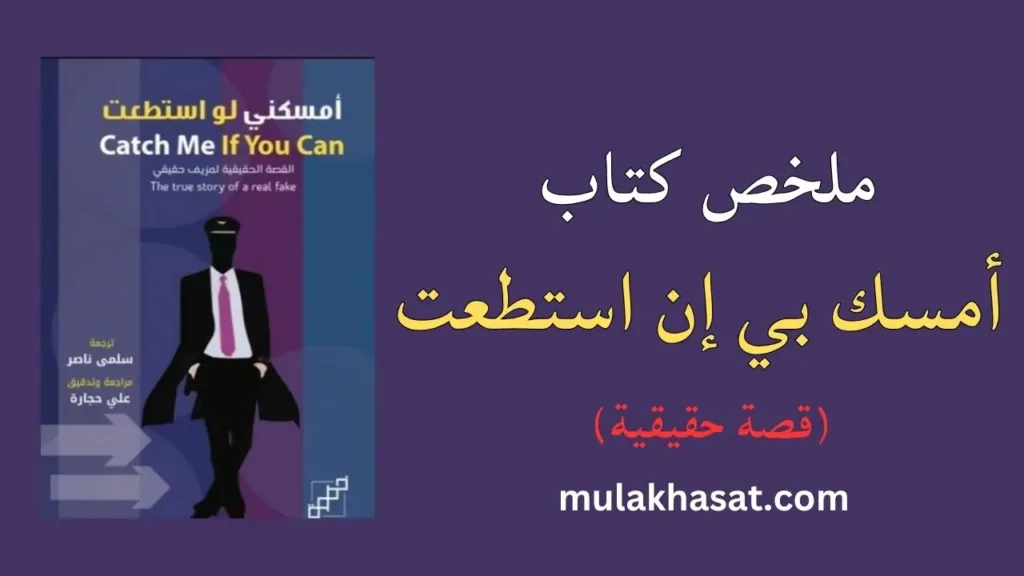
فرانك ويليام أباغنيل لم يكن مجرد محتال محترف، بل كان أسطورة حية في عالم الخداع والذكاء الفطري. وُلد عام 1948 في نيويورك، وفي سن مبكرة جدًا، دخل عالم الجريمة دون أن يحمل سلاحًا أو يهدد أحدًا، بل استخدم عقله وحده – عقله الحاد، وذاكرته القوية، وحضوره المذهل، وهي الصفات التي جعلته يصبح في نظر الكثيرين “أذكى محتال عرفه التاريخ الحديث”.
الكتاب “أمسك بي إن استطعت” هو سيرة ذاتية كتبها أباغنيل بالتعاون مع الكاتب ستان ردينغ. لكن ما يميّزه عن كتب السير المعتادة هو أنه يحكي القصة من الداخل، من منظور العقل المدبر، لا من وجهة نظر الضحية أو القانون. كل صفحة تشبه مشهداً من فيلم، لكن الفارق أن ما تقرأه حدث فعلاً.
فرانك لم يكن شخصًا عاديًا قرر فجأة أن يزوّر شيكًا أو ينتحل صفة ما. بل كان شابًا في السادسة عشرة من عمره حين بدأ رحلته، واللافت أنه لم يستخدم العنف قط. هو نفسه يقول:
“لم أؤذِ أحدًا قط، لم أطلق رصاصة، لم أسرق من أحد وجهاً لوجه. كل ما فعلته أنني أقنعت الناس بأنني شخص آخر.”
لم يكتفِ بانتحال هوية واحدة أو وظيفتين، بل تنقل بين كونِه قائد طائرة، طبيب أطفال، محامٍ، أستاذًا جامعيًا… وكأنه يختبر حدود الإمكانيات البشرية في التمثيل والإقناع. تنكّر خلف وجوه عدة، كل واحدة منها كانت كفيلة بأن تضعه في السجن لسنوات، لكنه كان دائمًا يهرب – ليس بالقوة، بل بالخدعة.
الكتاب ليس استعراض لحيل عبقرية، بل هو نافذة على عقل شابٍ ضائع، تأذى من انفصال والديه، وتحوّل ألمه إلى لعبة تحدٍ مع العالم. من البداية، لم يكن المال هو المحرك الوحيد، بل رغبة دفينة في السيطرة، في أن يشعر بأن له قيمة، ولو عن طريق الكذب.
بهذا المدخل، يرسم لنا أباغنيل طريقًا ستتفرّع منه قصص أغرب من الخيال، لكنها مبنية على وقائع دقيقة، بعضها موثق في تقارير الـFBI، والبعض الآخر يصعب تصديقه، لولا أن قائلها هو الرجل نفسه الذي عاشها كلها.
طفولة فرانك وبداية التحول
في قلب نيويورك، وُلد فرانك أباغنيل لأسرة متوسطة. كان والده رجل أعمال ناجحًا يتمتع بكاريزما خاصة، فيما كانت والدته فرنسية المولد، هادئة، أنيقة، ورزينة. لكن خلف هذا الهدوء، كانت تتشكل عاصفة غير مرئية في حياة الطفل الصغير.
في أحد أكثر مشاهد الكتاب ألمًا وإنسانية، يروي فرانك لحظة انكساره الأولى، حين أُجبر على الاختيار بين والديه بعد الطلاق. لم يكن يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حينها، لكن وقع الموقف على قلبه كان كالسقوط من مكان مرتفع دون شبكة أمان. قال بصراحة تخلو من التجميل:
“لم أستطع أن أختار. كنت أريد الاثنين، وبدلًا من ذلك، فقدت كليهما.”
هنا تبدأ أول شرارة للتحول. لم يكن في نية فرانك أن يصبح محتالًا. كان مجرد فتى يحاول الهرب من واقع مفكك، فبدأ بالبحث عن طريقة يُثبت بها لنفسه أنه ما زال يمتلك السيطرة. المال، الذي كان رمز الأمان العائلي سابقًا، أصبح الآن هدفًا مشوشًا يحاول أن يصل إليه بأي وسيلة.
كانت أولى محاولاته في الاحتيال بسيطة وساذجة، لكنها كانت ذكية بما يكفي لتدل على ما يمكن أن يصبح عليه لاحقًا. بدأ باستخدام دفتر شيكات والده دون علمه. لم يكن يعرف كيف يملأ الشيك بشكل صحيح، لكنه كان يلاحظ التفاصيل الصغيرة – طابع البنك، الحبر، التوقيع، وحتى تعابير وجه أمين الصندوق. وبحيلة ذكية، أقنعهم أن الشيك حقيقي، وحصل على أول مبلغ له: خمسون دولارًا.
ثم تطوّرت ألاعيبه شيئًا فشيئًا. بدأ بارتداء بدلة والده، وتزييف توقيعه في المدرسة، بل إنه كان يقلد صوته بدقة. وهنا، لم يعد الأمر مجرد تمرد مراهق، بل بدا كأنه مشروع عقل إجرامي يخطو أولى خطواته.
لكنه لم يكن ساذجًا. كان يعلم أنه يخالف القانون، وكان لديه وعي داخلي بأن كل ما يفعله زائف، لكنه اعتمد على “الفرصة الأولى“، تلك التي يغفل فيها الناس عن التفاصيل.
“الناس لا يسألون كثيرًا عندما يرون شابًا واثقًا بنفسه ويرتدي ربطة عنق أنيقة”، كما قال.
في هذا الجزء من حياته، لم يكن فرانك يحاول خداع العالم فقط، بل كان يخدع نفسه أيضًا – يقنعها أن كل ما يقوم به مجرد لعبة، مغامرة مؤقتة. لكن هذه اللعبة كانت على وشك أن تتحوّل إلى أسلوب حياة.
رحلة الاحتيال – الطيار الزائف
لم يكن فرانك أباغنيل يخطط لأن يصبح طيارًا، لكنه كان دائمًا يراقب التفاصيل الدقيقة في كل مكان يذهب إليه. وأثناء إحدى زياراته لأحد المطارات، لفت انتباهه الاحترام الذي يحظى به الطيارون، والسهولة التي يتحركون بها من بوابة إلى أخرى، دون أن يُطلب منهم شيء. وهنا ولدت الفكرة: لماذا لا أكون واحدًا منهم؟
بدأت خطته بالبحث والمراقبة. لم يستخدم أي برنامج حاسوب أو أدوات متقدمة – بل كان كل شيء قائمًا على الملاحظة والتفكير المنطقي. زار مطارات، قرأ مجلات طيران، وتعلّم أسماء الرتب وأنواع الطائرات. ثم استهدف شركة الطيران العملاقة آنذاك: “بان أميركان إيرلاينز – Pan Am”.
بذكاء حاد، اتصل بإدارة الشركة مدّعيًا أنه طيار جديد فقد زيه الرسمي. تمكّن من الحصول على زي كامل ببساطة عبر الإقناع واللعب على مشاعر المسؤولين. أما البطاقة التعريفية، فكانت من صُنعه، باستخدام أدوات بسيطة للغاية، لكنه كان يعرف كيف يظهرها بسرعة وبثقة تجعل من حوله لا يطلبون التحقق منها.
أصبح فرانك طيارًا “زائفًا” بجناحين حقيقيين. لم يكن يقود الطائرات، بل جلس دائمًا في مقاعد “المراقب” داخل قمرة القيادة. تنقّل بين عشرات المدن حول العالم، من نيويورك إلى روما، ومن طوكيو إلى ميامي، دون أن يدفع فلسًا واحدًا. استغل نظام يُعرف باسم “deadheading”، وهو نظام يسمح للطيارين بالسفر مجانًا للالتحاق برحلات أخرى. وكل ما كان عليه فعله هو ارتداء زيه والدخول بثقة.
يروي في الكتاب:
“لم يكن أحد يشك بي. كانوا يرون الزي، يسمعون لهجتي المهنية، ويفترضون أنني من الفريق. العالم يحب المظاهر.”
لم يكن الأمر مجرد سفر مجاني، بل كان يُقيم في أفخم الفنادق، يُستقبل بابتسامة من الطاقم الأرضي، ويحصل على بدل سفر نقدي من شركة “بان آم” تحت اسم طيارين حقيقيين.
في إحدى الحوادث المثيرة، اكتشف أنه يستطيع صرف شيكات مزوّرة باسم الشركة لأن الناس يثقون بالطيارين. كان ببساطة يكتب شيكًا عليه شعار “بان آم” ويوقعه باسم أحد الطيارين الكبار الذين عرف أسماءهم من لوحات الرحلات. وكانت البنوك تصدّق، لأن “من يرتدي الزي لا يمكن أن يكون نصّابًا”.
طاف فرانك أكثر من 250,000 ميل جوي، زار 26 دولة، وحصل على آلاف الدولارات، فقط لأنه كان يعرف كيف يقنع الناس أنه “رجل الجو”. لم يكن بحاجة إلى أدوات متطورة، بل إلى ثقة عالية بالنفس، لباقة بالكلام، وإلمام دقيق بالسياق.
لم يكن يتفاخر بجرائمه، لكنه اعترف:
“العالم يريد أن يُخدع… فقط إذا عرف كيف يبدو الخداع.”
الطبيب، المحامي، والأستاذ الجامعي
بعد أن أرهقه السفر المتواصل كـ”طيار”، قرر فرانك أباغنيل أن يخوض مغامرات جديدة، لا تقل جرأة وخطورة. انتقل من السماء إلى الأرض، ومن المطارات إلى المستشفيات وقاعات المحاكم والجامعات. كان مستعدًا ليلعب أي دور، بشرط أن يمنحه سلطة وهيبة… وأمانًا مؤقتًا من الملاحقة.
بدأ أولًا بانتحال صفة طبيب أطفال. كان عمره لا يتجاوز التاسعة عشرة، لكن ملامحه الهادئة، أسلوبه الجاد، وهدوؤه تحت الضغط أعطته مصداقية مفاجئة. حصل على عمل في مستشفى صغير بمدينة جورجيا، متخفيًا خلف لقب “الدكتور فرانك كونرز”.
لم يكن يملك أدنى خبرة طبية، لكن عرف كيف يتصرف. اعتمد على حيلة بسيطة: “راقب ولا تلمس”. كان يشرف على الفريق، يناقش الحالات، لكن لا يضع يده أبدًا على مريض.
يروي في أحد المواقف الساخرة من الكتاب:
“أكثر ما كان يخيفني أن يسقط أحد الأطفال أمامي مغشيًا عليه… كنت سأصرخ مع الممرضة بدلًا من أن أطلب الإسعاف!”
وبطريقة لا تخلو من الحظ، استمر في عمله لعدة أشهر دون اكتشاف. وكان يحمي نفسه دائمًا بجدار من الجدية والثقة. فالجميع يهاب الطبيب الذي يبدو أنه يعرف ما يفعل، ولا أحد يتوقع أن يكون مجرد شاب يرتدي المعطف الأبيض.
بعدها، اتجه إلى المحاماة. قرأ بتركيز شديد قوانين ولاية لويزيانا، واستغل ثغرة قانونية تمنحه الحق في دخول اختبار المحاماة رغم أنه لا يملك شهادة قانون رسمية. جلس لثلاثة أسابيع يقرأ ويحلل ويذاكر بمفرده… ونجح.
نعم، نجح بالفعل في اختبار حقيقي، لتُمنح له الرخصة القانونية. ومن هناك، بدأ العمل في مكتب النائب العام كمساعد قانوني، بكل ثقة، وسط نخبة من المحامين!
أما مغامرته كأستاذ جامعي، فكانت واحدة من أكثر فصول حياته إثارة وسخرية. في جامعة “بريغهام يونغ“، قدّم نفسه على أنه أستاذ جامعي بديل في قسم علم الاجتماع. لم يسأله أحد عن أوراق اعتماد، بل رحّبوا به بسبب مظهره الناضج وقدرته على الإلقاء.
كان يحضر إلى المحاضرات بثقة، يختار مواضيع عامة، ويعتمد على النقاش بدلًا من التلقين.
قال عن تلك التجربة:
“أحيانًا كنت أتعلم الموضوع مع الطلاب في الليلة التي تسبق المحاضرة.”
لكن المدهش، أن الطلاب أحبوه، والإدارة لم تشك لحظة بكونه محتالًا.
كل هذه الشخصيات التي تَقمّصها لم تكن مبنية على معرفة، بل على الجرأة، الملاحظة الحادة، والثقة المطلقة بالنفس. لم يكن عبقريًا، لكنه كان ذكيًا بما يكفي ليعرف ماذا يقول، ومتى ينسحب.
وفي جوهر الأمر، لم يكن فرانك يهدف فقط إلى المال، بل إلى إثبات أنه قادر على خداع نظام كامل فقط بذكائه، وأن العالم مليء بالثغرات، بشرط أن تمتلك الجرأة لاختراقها.
مطاردات الشرطة ومحاولات القبض عليه
بينما كان فرانك أباغنيل يعيش حياة مزدوجة ويتنقل من شخصية إلى أخرى، كانت هناك قوة واحدة بدأت تلاحظ هذا الوجود الغامض: مكتب التحقيقات الفيدرالي – الـFBI.
وضع المكتب قضية الاحتيالات الغريبة والمتكررة التي طالت شركات الطيران، البنوك، والمستشفيات تحت مجهر التحري، ليظهر في الصورة اسم واحد يتكرر بخجل في الظل: شاب صغير السن، بارع التنكر، يتقن الحديث، ولا يترك أثرًا خلفه.
دخل العميل الخاص جوزيف شي (Joseph Shea) المشهد. رجل صارم، شديد التركيز، ومهووس بالإمساك بالمجرمين الأذكياء. ومع الوقت، تحولت المطاردة بين فرانك وشي إلى ما يُشبه لعبة شطرنج طويلة على رقعة العالم.
كان فرانك دائمًا متقدمًا بخطوة. في كل مرة يقترب فيها الفريق الفيدرالي من الإمساك به، كان فرانك قد غيّر هويته، مدينته، أو حتى مهنته.
يروي الكتاب إحدى هذه اللحظات عندما اكتشف فرانك أن عملاء الـFBI يراقبون أحد الفنادق التي نزل بها. بدلًا من الهرب فورًا، ارتدى زي مضيف خدمة الغرف، وخرج من الباب الخلفي ممسكًا بعربة الطعام. وقف أمامهم بابتسامة مزيفة، ودخل في الزحام قبل أن يدركوا من يكون.
قال لاحقًا:
“إذا تصرفت وكأنك تنتمي إلى المكان، لن يطرح أحد الأسئلة.”
وفي أحد أكثر المواقف جرأة، وجد نفسه محاصرًا في مطار، حيث تم تعميم صورته. فما كان منه إلا أن تظاهر بأنه ضابط من جهاز الهجرة، يُحقق في قضية شاب ينتحل صفة طيار. وقدّم نفسه على أنه جزء من الفريق الذي جاء للقبض على “فرانك”! وهكذا نجا… بتمثيل مذهل داخل تمثيله.
اعتمد فرانك في هروبه على التفاصيل الصغيرة. لم يكن يمتلك قوة جسدية أو فريقًا يساعده، لكنه كان يلاحظ نقاط الضعف: حارس مرهق، موظف ساذج، نظام أمني قديم، أو حتى موظفة استقبال مبهورة بمظهره.
كان يعرف كيف يستغل اللحظة. مرةً زور شيكًا باسم شركة معروفة، ووضعه في ماكينة الإيداع في البنك بعد أن أقنع موظفة بأنه على عجلة، فمر الشيك دون مراجعة.
حتى العميل شي نفسه اعترف لاحقًا في مذكراته أن فرانك “كان مختلفًا عن كل من طاردناهم من قبل. لم يكن مجرمًا تقليديًا… كان فنانًا”.
في كل مرة كانوا يعتقدون أن القبض عليه مسألة وقت، كان فرانك يخرج بخطة جديدة لا تخطر على بال. وكان أقرب إلى “ظل” يتلاشى كلما اقترب الضوء.
الوقوع في الفخ – القبض عليه في فرنسا
بعد سنوات طويلة من المطاردات، الهويات المزيفة، والحياة التي لا تنام، جاء اليوم الذي خُتمت فيه مغامرة فرانك أباغنيل… في مدينة بوردو الفرنسية، حيث انتهى العرض الذي طال لسنوات.
كان فرانك قد ظن أن أوروبا ستكون ملاذًا آمنًا، خصوصًا بعد أن بدأ يُطوّر أساليبه أكثر فأكثر، لكن المفاجأة جاءت من حيث لم يتوقع.
تم التعرف عليه بعد أن لاحظ أحد موظفي الخطوط الجوية الفرنسية تفاصيل وجهه من ملصق تعميم صادر عن الإنتربول. وبهدوء شديد، أبلغ السلطات.
في لحظة، انتقل فرانك من كونه “الطيار الساحر” و”الدكتور المحترم” إلى مجرم مكبّل بالأغلال في زنزانة فرنسية رطبة، ضيقة، خالية من النوافذ.
كتب عن هذه اللحظة لاحقًا:
“في البداية لم أصدق أن الأمر انتهى. جلست في الزنزانة كمن ينتظر نداء الركاب الأخير، على أمل أن يكون هناك طائرة تهرب بي من جديد.”
لكن الطائرة لم تأتِ.
وحين بدأت السلطات الفرنسية التحقيق معه، اكتشفوا أن ملفه معقّد لأبعد الحدود. أكثر من 26 جنسية وهمية، عشرات من الشيكات المزورة، جرائم في بلدان مختلفة، ومطالبات قضائية من أكثر من 12 دولة!
تمت محاكمته أولًا في فرنسا، وصدر حكم بسجنه لمدة عام كامل. وكانت تلك التجربة مريرة، لأن السجن الفرنسي في ذلك الوقت لم يكن مكانًا للراحة أو التأهيل، بل أقرب إلى الجحيم.
خرج بعدها ليُسلّم إلى السلطات السويدية، حيث واجه اتهامات بالتزوير أيضًا.
لكن الولايات المتحدة – التي وضعت على ملفه علامة “أولوية قصوى” – ضغطت لتستلمه، وتم ترحيله لاحقًا.
الغريب في قصة فرانك أن سقوطه لم يكن لحظة مذلة أو عنيفة، بل جاءت كخاتمة طبيعية لرجل استنزف كل حيله، ولم يعد هناك المزيد ليخدع به العالم.
كتب في الكتاب:
“كنت أعيش كل يوم وأنا أعلم أن الغد قد يكون اليوم الأخير. وعندما أتى، شعرت بالارتياح أكثر من الخوف.”
لقد خدع العالم، لكن في النهاية، الحياة هي من خدعته وأعادته إلى واقعه، دون زي أو هوية.
التوبة والتحول – من محتال إلى مستشار أمني
بعد أن قضى فرانك أباغنيل نحو خمس سنوات في السجون الفرنسية، السويدية، والأمريكية، كان أمامه طريقان لا ثالث لهما: إما أن يعود إلى الظل ويعيد الكرّة، أو أن يستثمر ما تعلمه في خدمة من كانوا يطاردونه يومًا.
وهنا ظهرت المفارقة الأكبر في قصته…
مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي سعى طويلًا خلفه، هو من مدّ له اليد أخيرًا.
لم يكن هذا العرض عاديًا. لم يُطلب منه فقط التوقف عن التزوير، بل طُلب منه أن يشارك معرفته… أن يعلم الـFBI كيف يفكر المحتال، كيف يخدع الناس، وكيف يخترق الأنظمة.
فمن يعرف الثغرات أكثر ممن صنعها؟
قال فرانك في إحدى محاضراته:
“عندما كنت أزور الشيكات، كنت فقط أستخدم المنطق. لم أخترق النظام، بل استغليت ثقته. الآن، أُعلم الآخرين كيف لا يثقون بسهولة.”
وهكذا بدأ فصل جديد في حياته، هذه المرة دون أقنعة.
أصبح خبيرًا في أمن الوثائق والتزوير، وساهم في تطوير بروتوكولات التحقق من الهوية، وأنظمة فحص الشيكات، وحتى إجراءات التوظيف في البنوك والمؤسسات الكبرى.
وبفضل خبرته الفريدة، بدأ يُستدعى كمستشار في قضايا دولية، وألقى مئات المحاضرات في الجامعات، الشركات، والمؤتمرات الأمنية، ليشارك قصته كتحذير ودروس مستفادة.
عمله لم يكن سطحيًا، بل مؤثرًا في البنية التحتية للأنظمة المالية. وهو ما جعل أحد عملاء الـFBI السابقين يصرّح في مقابلة:
“لقد ألحق بنا فرانك ضررًا كبيرًا، لكنه ساعدنا على سدّ ثقوب لم نكن نعلم بوجودها أصلاً.”
هذا التحول من مجرم عبقري إلى خبير أمن محترم، لم يكن مجرد تمويه جديد، بل قرار حقيقي بالتوبة والتغيير.
وقد قالها بنفسه:
“كنت أعيش حياة مزيفة، حتى تعبت من الاختباء. الحرية الحقيقية ليست في الهروب من القانون، بل في العيش بسلام مع النفس.”
دروس وعِبر من القصة
قصة فرانك أباغنيل ليست قصة مغامرات خارجة عن المألوف، ولا حكاية لصّ ذكي تلاعب بالعالم وانتهى به المطاف في قبضة العدالة. إنها مرآة لحقيقتين متناقضتين تسكنان الإنسان: عبقرية يمكن أن تُستخدم في الخير أو الشر، وفراغ داخلي لا يملؤه المال أو المغامرة.
أول ما نتعلمه من قصة فرانك هو أن الذكاء وحده لا يصنع حياة ناجحة.
فرانك كان موهوبًا بشكل نادر؛ تقمّص شخصيات لا علاقة له بها، دخل قاعات الجراحة، ألقى محاضرات قانونية، وأدار فصولًا جامعية، كل ذلك دون أي خلفية علمية أو شهادات.
لكن رغم براعته، ظل يهرب، خائفًا من انكشاف أمره، ملاحَقًا من الجميع، ومن نفسه أولًا.
كتب في إحدى صفحات الكتاب:
“خدعت الجميع، لكن في النهاية كنت الوحيد الذي لم أستطع خداعه.”
ومن هنا تأتي الدرس الثاني: النجاح الحقيقي لا يُقاس بما تستطيع أن تحصل عليه من الناس، بل بما تزرعه فيهم.
فرانك في شبابه سلب الثقة من كل من قابله، لكنه في نضجه، كرّس حياته ليعيد هذه الثقة للعالم.
ما بين فرانك “المزور” وفرانك “المستشار الأمني”، هناك فجوة اسمها القيم. وهي ما غابت عن مرحلته الأولى، فدفع الثمن.
قصة فرانك تعلمنا أيضًا أن البدايات لا تحدد النهايات.
طفل تشتت بين والديه، انجرف نحو الخداع، عاش في الظل، لكنه امتلك الشجاعة ليعترف، ويبدأ من جديد.
وكما قال في إحدى خطاباته:
“من السهل أن تهرب، الأصعب أن تواجه ما فعلت… وأن تبني حياة تستحق أن تعيشها.”
أخيرًا، قصة “أمسكني إن استطعت” ليست فقط رواية حقيقية شيقة، بل تذكير بأن الذكاء حين لا يُضبط بالقيم، يتحوّل إلى كارثة. وأننا مهما تفوقنا أو نجحنا، فـالصدق والضمير هما البوصلة الوحيدة التي تقودنا لنهاية كريمة.
في الختام – بين الحقيقة والأسطورة
تحوّلت قصة فرانك أباغنيل من ملف في أدراج الـFBI إلى أسطورة عالمية عندما قررت هوليوود أن تحكيها على الشاشة الكبيرة.
في عام 2002، خرج إلى النور فيلم “Catch Me If You Can” من إخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة ليوناردو دي كابريو في دور فرانك، وتوم هانكس في دور العميل الفيدرالي “كارل هانراتي”، المستوحى من “جوزيف شي” الحقيقي.
الفيلم نقل تفاصيل القصة بطريقة درامية وسينمائية جذابة، لكنه ظل وفيًا لجوهر الحكاية: العبقرية المضللة، المطاردات الشرسة، والسقوط المفاجئ الذي مهّد لطريق التوبة.
أداء دي كابريو لم يكن تمثيلًا فقط، بل تجسيدًا حقيقيًا لمعاناة شاب أذكى من سنّه، ضائع بين رغبته في إثبات نفسه وألمه الداخلي بعد تفكك أسرته.
أما توم هانكس، فقد مثّل ذلك الصوت الثابت للقانون، الذي لم يكن يسعى للانتقام، بل للفهم – وربما حتى للإنقاذ.
هذا الفيلم لم يكن مجرد نجاح تجاري، بل أثار وعيًا عالميًا حول جرائم الاحتيال المالي وانتحال الشخصيات، وفتح العيون على مدى هشاشة الأنظمة التي يمكن التلاعب بها ببعض الذكاء وقليل من الجرأة.
وبعد عرض الفيلم، أصبحت قصة فرانك تُدرَّس في بعض الجامعات كمثال على الهندسة الاجتماعية وضعف النظم الأمنية، بل وأصبح يُستدعى بنفسه في المؤتمرات ليروي قصته في سياق تعليمي.
الخط الفاصل بين الحقيقة والأسطورة في قصة فرانك لم يكن ضبابيًا، بل إن الأسطورة انبثقت من صدق التفاصيل، ومن اعتراف رجل قال في النهاية:
“لم أكن فخورًا بما فعلت، لكنني فخور بما أصبحت عليه.”